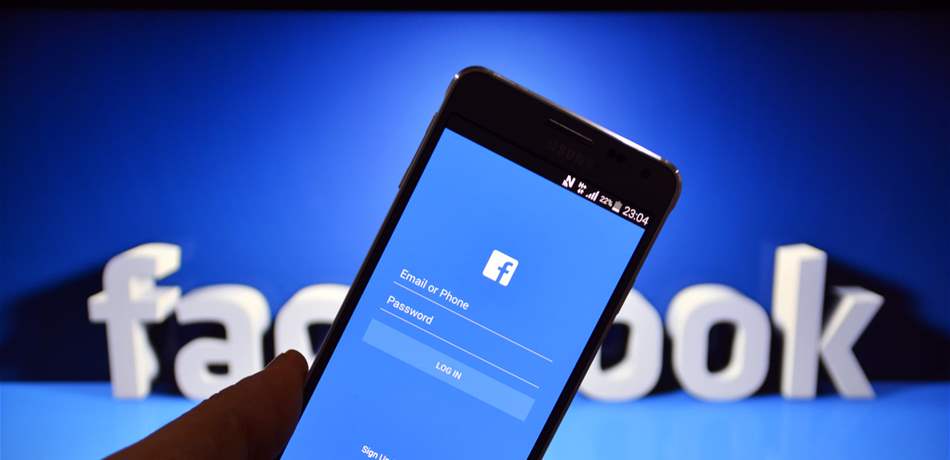
قبل أيام تعطّل موقع “فيسبوك” وتطبيقي “انستغرام” و”واتس آب” بشكل مفاجئ لبعض الوقت، وتعطلت معهم مصالح وأنشطة وقرائح عشرات الملايين حول العالم من أنصار ومحبي ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تكشف الشركات مشغّلة المواقع عن سبب العطل الذي تسبّب بـ “شلل” عالمي، فبقي الحدثُ غامضاً وبلا تفسير؟!
بعدها بيومين تصدّر خبر استجابة موقع “انستغرام” لمقتضيات تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية وحذف حسابات أبرز قادته، ومن بينهم الجنرال قاسم سليماني.
قبل ذلك، وفي سياق تعاملها مع تداعيات جريمة المسجدين في “كرايس تشيرش” على يد إرهابي متطرف، بادرت حكومة استراليا إلى سنّ قانون لمعاقبة شركات التقنية، بما في ذلك حبس مسؤوليها التنفيذيين، في حال استضافتها لمحتوى عنيف على منصاتها أو تساهلت في إيواء وترويج خطاب الكراهية والتطرف بدعوى حرية تداول المعلومات، خصوصاً وأن الإرهابي بثّ جريمته المقيتة ضدّ المصلين الأبرياء مباشرة على الهواء وعلى مدى 17 دقيقة!
وسط هذه الصورة، يناقش المنظمون الفيدراليون في الولايات المتحدة ما إذا كان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مسؤولًا شخصيًا عن سوء إدارة البيانات الخاصة بالمستخدمين، وكيفية مساءلته.
هل بدأت إعادة النظر بحدود سلطة تخطي القوانين الوطنية أو الامتيازات الممنوحة لشركات التقنية وتكنولوجيا الاتصالات ووسائل التواصل بذريعة الحريات من أجل ضبط المحتوى وفق الأطر الأخلاقية المتعارف عليها، خصوصاً بعد تكاثر ظواهر نشر وتعميم الأخبار الكاذبة والمواد ذات المحتوى العنيف أو التي تحضّ على الكراهية والقتل كالتي دأب تنظيم “داعش” الإرهابي على نشرها بحرفيةٍ عالية في فضاء واسع، مرن، وصادم؟
هذه الخطوة في حال اعتمادها ستعني اعتبار الشركات المعنية شريكاً يتحمل جزءاً من مسؤولية ما تعممه مواقعها وتطبيقاتها، وبالتالي إخضاعها إلى سلطة القانون، أو القوانين الوطنية (المحلية) لناحية اعتبارات القيم والسلوكيات والأمن الاجتماعي والوطني، وبالفعل فقد عمدت دول عدة إلى سنّ تشريعات بهذا الخصوص، وصدرت أحكام قضائية بحق “غوغل” و”يوتيوب” و”فيسبوك” للسماح بنشر ما اعتبر مسّاً بالقيم أو الأخلاقيات أو تهديداً للأمن.
يدرك أهل الاختصاص أن خطوة كهذه لن تكون سهلة، وعودة بالذاكرة إلى عقد التسعينيات من القرن العشرين الذي شهر نقاشات فلسفية وقانونية وأخلاقية واسعة رافقت القفزة الهائلة التي كانت تحققها تقنيات عالم الاتصال والبثّ الفضائي، ما اعتبر حينها، تخطياً للقوانين المحلية والسيادات الوطنية للدول.
تتمسك شركات التقنية، دفاعاً عن نفسها، بالقاعدة الأساسية للفكر لليبرالي، وهي أن حق الحرية مكفول، وأن المساس به مسٌّ بحرية الرأي والكلمة. لكن في المقابل، من قال إن نشر خطاب الكراهية والحض على القتل والتطرف حرية؟ ثم من قال أيضاً إنه بذريعة الحرية يحق لهذا الشركات أن تتخطى السيادات الوطنية لناحية العمل والاستثمار وعدم الخضوع للنظام الضربيي أو الإفلات من تبعات الاستخدام السيء لتطبيقاتها؟ خصوصاً وأن هذه الشركات تضخمت وتوسّعت وباتت تمارس الاحتكار والنفوذ بشكل يتجاوز سيطرة بعض الدول بحدّ ذاتها! وقبل كل ذلك وبعده، هل يميز المتابعون من غير المختصين وسط الدفق الرهيب للمعلومات والمواد بين ما هو صادق وما هو مزيف من أخبار؟
وإزاء تحديات نشر المحتوى المؤذي، وتسطيح القضايا الكبرى، والإفلات من الرقابة والتهرّب الضريبي، وتخطي السلطات والقوانين المحلية، يبقى أن «التواصل الاجتماعي» في زمن الجيوش الالكترونية ومقتنصي الشهرة هو آخر ما تهدف إليه هذه الشركات.
وطالما الشيءُ بالشيء يذكر، هنا في لبنان، يتراشق السياسيون والمسؤولون بالتغريدات، حتى ولو كانت تتصل بشؤون كبرى لا يجدر طرحها إلا في مقام رسم السياسات ومعالجة الملفات، كالموازنة والعجز وحجم القطاع العام ومقترحات ترشيد الانفاق… وهم في عبقريتهم هذه لا يختلفون عمن يخوض معارك انتخابية حامية معتمداً على رصيده من “اللايكات”.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.
لبنان 24
 موقع إرزي
موقع إرزي






